لطالما كانت مقاربتي للوضع في لبنان، تنطلق من تشبيه هذا البلد بالمبنى المصدوع، المهدّد بأن يهوي بنا جميعا فوق ما تبقّى من أجساد، لم يهشّمها إنفجار المرفأ، ولم تلتهمها الحرائق، ولم يخنقها سيل غادر، ولم تُسحق على إحدى الطرقات القاتلة، ونجت من رصاصات لصّ أو متصنّع فرح، يخطّ رصاص جهله في صدر، عابر سبيل.
للمصادفة، كتبت أمس عن الإستهتار في التعاطي مع الملفّات المتزاحمة، معبّرا عن هواجسي من أن يهوي السّقف فوق أجسادنا، لم يهوِ سقف الوطن، لكن سقف أحد المدارس هو الذي هوى فوق جسد الأطفال، جارحا طفلة، وممزّقا أوراق وردة في ربيع العمر، قطفها الإهمال في غير أوانها.
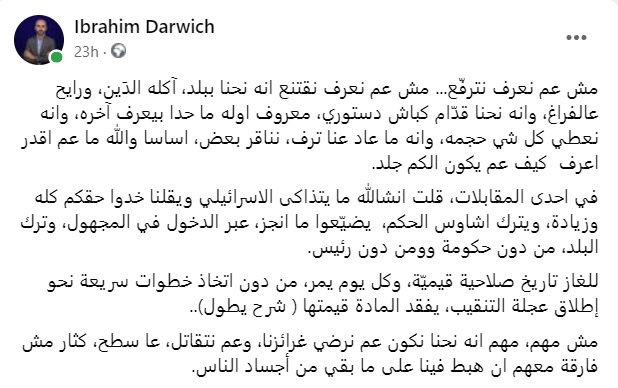
هو الوقت للعزاء فقط، فالمصيبة كبيرة جدا، والطفلة، ليس إبنة ذويها فقط، بل هي إبنة كل مقيم فوق هذه المساحة المحاطة بالكثير من الوجع، وقد يكون وفاة الطفلة جرس إنذار رباني، لدفع كثيرين الى متابعة الكثير من الامور المهملة، في المنازل، على الطرقات، في السيارات، في المدارس، تحت ذريعة الازمة، وغايب ترتيب الأولويات، بما يهدد بأخطار محدقة.
في هذا البلد، لا زال هناك الكثير من السقوف المهدّدة بالسقوط، ما لم يتم إستشعار حجم الخطر الذي نمرّ به، وحجم الاهمال الذي يواصل تشليع ما تبقّى من أركان في هذه الدولة، إنما أحاول أن أعبر بين ثنايا الوجع، أصرخ بأرق في وجه مقامري السياسة، ومشعوذي الاقتصاد، وحواة السياسة، ملاطماً بيدين مرتجفتين متعبتين البطون المنتفخة، عابرا بين لغات الابجدية باحثا عن ضمائر منفصلة، علها تتصل، فلتجم سطوة لاعبي السوق السوداء السياسية والاقتصادية ممن ألهاهم الكباش، وتسجيل النقاط، وصموا آذانهم، عن اوجاع أبنائهم، وانتظروا إيماءات وإيحاءات الخارج.
لو كان أبناء هذا البلد ضنينين بوطنهم، لما طفا الى السطح فسادهم الذي عمّ البر والبحر بما كسبوا، ولما تهافت الناس لينهشوا بعضهم بعضهم، ولما فتحت مدرسة أبوابها لتستقبل الطلاب، تحت سقف، لم تختبر أهليّته.
أخاف أن يمرّ وفاة الطالبة ماغي محمود مرور الكرام، فنقرأ جميعا الخبر بحسرة وصمت، بينما تستكمل كياناتنا البشرية رحلة تحولّها الى آلات بشريّة مبرمجة، وتتحوّل الجثث مجرّد أرقام، تحصيها حواسنا المبرمجة، المجرّدة من أيّ تفاعل إنساني، كما الكثير من القضايا التي أفقدها الحقد والحسابات الضيّقة مضمونها وجوهرها، ويصبح الموت أعجز من أن يحرّك ساكناً فينا، قتل منذ زمن، وكنّا لا نزال نعتقد أنه لا زال على قيد الحياة.
 العربي المستقل
العربي المستقل


